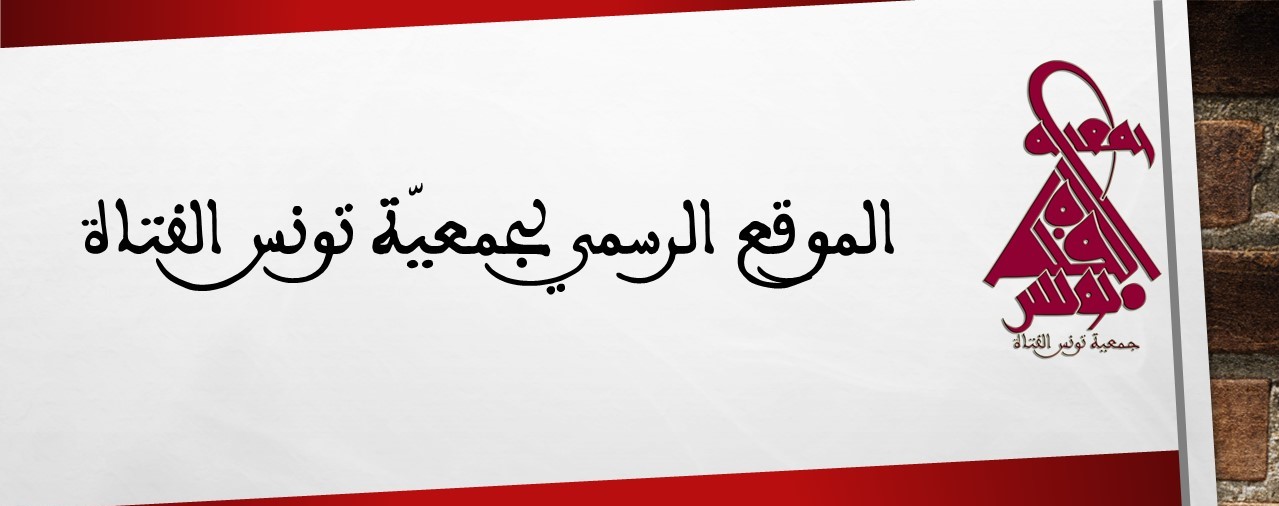لبنان: أزمة نظام أم أزمة هوية؟
بقلم: مريم بن عيسى
في قلب منطقة الشرق الأوسط المضطربة، يقف لبنان على حافة الهاوية، محاطًا بأزمات متشابكة تهدد كيانه، فرغم أنه بلد صغير من حيث المساحة الجغرافية لكنه يواجه تحديات تعادل تلك التي تواجه دولًا كبرى. من انهيار اقتصادي مدمر إلى انسداد سياسي عميق، يعيش لبنان منذ القديم مراحل عصيبة حيث تتداخل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فما الذي يجعل هذه الأزمة معقدة إلى هذا الحد؟ وهل يمكن الخروج منها؟
لبنان يشهد منعطفًا حاسمًا في تاريخه المعاصر، فبين انهيار الأوضاع المعيشية واحتدام الصراع السياسي، تبرز قضية المسؤولية عن الأزمة والرؤية لمستقبل هذا البلد المنقسم كأولوية. منذ توقيع اتفاق الطائف عام 1989 الذي على أساسه تم وقف الحرب الأهلية، لم تتوقف الأزمات عن تهديد استقرار لبنان، الاتفاق الذي كان يهدف إلى تعزيز التوافق الوطني تحول مع مرور الوقت إلى تكريس المحاصصة الطائفية ما جعل الإصلاحات الجذرية بعيدة المنال.
الأزمة اللبنانية: نظرة تاريخية
لبنان، البلد الصغير، الذي يتميز بتنوعه الطائفي والثقافي، وهذا التنوع الذي كان يمكن أن يكون مصدر قوة أصبح في الوقت ذاته مصدراً للصراعات، ولفهم الأزمة الحالية، من الضروري العودة إلى جذور النظام السياسي والاجتماعي اللبناني، الذي تأسس على المحاصصة الطائفية منذ الاستقلال عام 1943.
استقلال لبنان أتى بثمن باهظ، نظام سياسي طائفي يقسم المناصب العليا بين الطوائف المختلفة، في محاولة للحفاظ على التوازن فرئاسة الجمهورية للمسيحيين الموارنة ورئاسة الحكومة للسنة ورئاسة البرلمان للشيعة، ورغم أن هذا النظام أسهم في الاستقرار على المدى القصير، إلا أنه أدى إلى تدهور المؤسسات العامة وفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية.
الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) كانت لحظة فارقة في تاريخ البلد، حيث انفجرت التوترات الطائفية وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا ودمار البنية التحتية، هذه الحرب التي تداخلت فيها مصالح إقليمية ودولية تركت جروحاً عميقة في النسيج الاجتماعي للبنان مما جعل إعادة بناء الدولة تحدياً كبيراً، ثم جاء الطائف كحل سياسي لإنهاء الحرب لكنه حمل في طياته بذور أزمة مستمرة بسبب تكريسه للمحاصصة الطائفية بدلًا من إرساء قواعد دولة مدنية تقوم على الكفاءة والمواطنة.
أزمات متعددة تتداخل
في أكتوبر 2019 وإلى حدود 2021 (ما يعرف بانتفاضة 17 تشرين)، شهد لبنان انتفاضة شعبية غير مسبوقة رفعت شعارات تُطالب بإسقاط النظام الطائفي ومحاسبة الفاسدين، توسعت هذه الحركة لتشمل فئات واسعة من المجتمع، لكنها فقدت زخمها تدريجيًا بسبب غياب قيادة موحدة وانقسامات داخلية، ورغم ذلك فإنها أثبتت أن هناك رغبة حقيقية لدى العديد من اللبنانيين في التغيير. الاحتجاجات أظهرت أيضاً تنامي الوعي الشعبي بأهمية بناء دولة مدنية تعكس تطلعات الجميع، إلا أن التحديات المتمثلة في السيطرة الطائفية والمحسوبيات السياسية عرقلت تحويل هذه الرغبة إلى واقع ملموس وعاد لبنان الى المربع السيء.
فاليوم يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث، فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها منذ عام 2019، والمصارف أغلقت أبوابها أمام المودعين، مما ترك المواطنين في مواجهة أزمة سيولة خانقة مع معدلات تضخم مرتفعة وباتت السلع الأساسية مثل الخبز والوقود بعيدة عن متناول الكثيرين.
الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية زاد الوضع سوءا. قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا دون تقديم خدمة مستدامة، إلى جانب ذلك، تعاني البلاد من نزيف الكفاءات البشرية حيث غادر مئات الآلاف من اللبنانيين البلاد بحثًا عن فرص أفضل وعن ملجأ آمن بعيدا عن الحروب، ما أدى إلى تدهور عدة قطاعات حيوية وحدوث شغور فيها.
التأثير الإقليمي والدولي
لا يمكن فهم الأزمة اللبنانية بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي، فقد تأثر لبنان بشكل مباشر بالصراعات الإقليمية خاصة للدول المحاذية له التي زادت من الضغط عليه. كما أن التدخلات الخارجية سواء من قبل إيران أو دول الخليج أو القوى الغربية أسهمت في تعميق الانقسامات الداخلية وتعقيد عملية اتخاذ القرار.
وفي ظل غياب توافق داخلي حقيقي، أصبحت السياسة اللبنانية رهينة للأجندات الخارجية مما أضعف قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
أزمة نظام أم أزمة هوية؟
لبنان يعاني من أزمة مزدوجة: أزمة نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية وأزمة هوية وطنية وغياب رؤية موحدة للدولة مما أدى إلى تعميق الانقسامات، والحل قد يكمن في بناء دولة مدنية تقوم على أساس المواطنة والكفاءة بدلًا من الانتماءات الطائفية، وهو أمر يتطلب توافقًا شعبيًا وإرادة سياسية حقيقية. من جهة أخرى، ترتبط أزمة الهوية بعدم وجود توافق على ماهية لبنان ودوره في المنطقة، فهناك من يرى لبنان كدولة ذات طابع غربي وانفتاح اقتصادي، فيما يرى آخرون أنه جزء لا يتجزأ من العالم العربي ومقاومته للتدخلات الخارجية.
لا يمكن للبنان أن يتجاوز أزمته دون إصلاح جذري للنظام السياسي والانتقال إلى نظام مدني وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد وإنشاء قضاء مستقل وهي جميعها خطوات ضرورية، كذلك دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز الوعي الشعبي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا، لكن هذه الإصلاحات تتطلب أيضًا توافقًا داخليًا ودعمًا خارجيًا فالمؤسسات الدولية قد تكون شريكًا أساسيًا في تقديم المساعدة التقنية والمالية، بشرط تنفيذ إصلاحات حقيقية تعيد بناء الثقة.
الانتخابات الرئاسية: فرصة أم تهديد؟
وسط هذه الأزمات، تقف الانتخابات الرئاسية الحالية في لبنان كنقطة تحول مهمة، هذه الانتخابات تمثل فرصة لتغيير المشهد السياسي إذا تمكنت القوى الإصلاحية من توحيد صفوفها وتقديم مرشحين يعبرون عن تطلعات الشعب، لكن في ظل هيمنة القوى التقليدية، قد تكون هذه الانتخابات مجرد إعادة إنتاج للأزمة إذا استمر النظام الطائفي في فرض شروطه، كما إن الرهان على الانتخابات كوسيلة للتغيير يتطلب أيضًا وعيًا شعبيًا أكبر وقدرة على مراقبة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها فإصلاح النظام يبدأ من صندوق الاقتراع لكنه لا ينتهي هناك.
لبنان يقف اليوم على مفترق طرق، والأزمات التي يواجهها ليست مستحيلة الحل، لكنها تتطلب قيادة جريئة وشجاعة لمواجهة التحديات. السؤال الكبير هو: هل يمكن للبنانيين تجاوز انتماءاتهم الطائفية وبناء دولة حديثة تُلبي تطلعات الجميع؟
نُشر هذا المقال بمجلّة حروف حرّة، العدد 37، شتاء 2025
لتحميل كامل العدد: http://tiny.cc/hourouf37